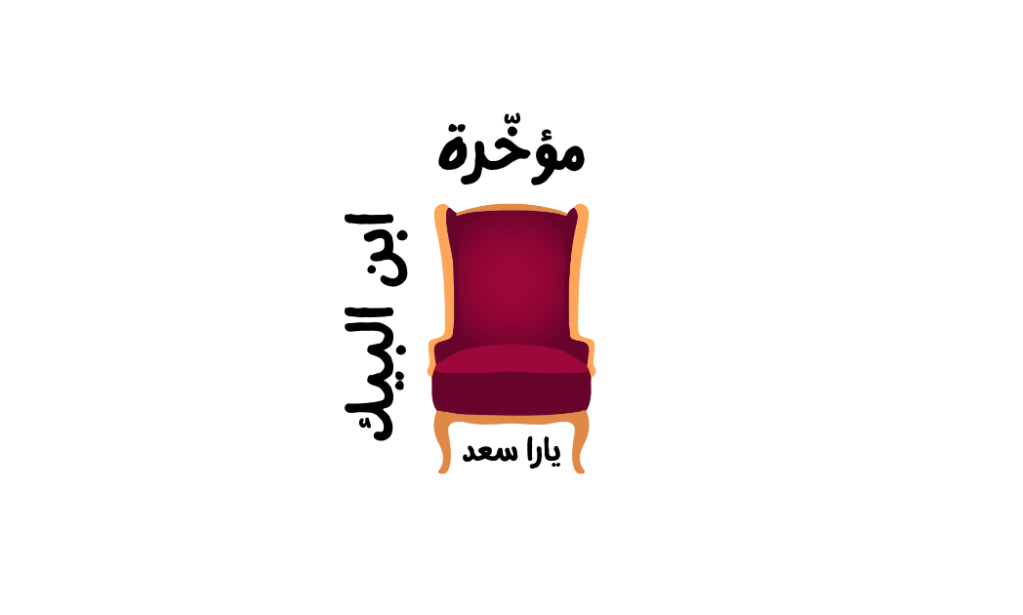
لقائي الأوّل بها كان قبل الانتخابات البرلمانيّة بأسابيع. يومها تطوّعت في حزب «الرّؤى البيضاء». كانت مُهمّتي أن أجول بين النّاس، لأشرح برنامج الحزب، وأُقنعهم بانتخاب البيك الصّغير ابن البيك الكبير، لتنال مؤخرته شرف الالتصاق بكراسي مجلس النواب.
نجح البيك الصّغير في الانتخابات، وصار بيكًا كبيرًا، ورئيسًا للحزب أيضًا. الحزب الّذي ورثَه أبي عن جدّي، وورثتُه عن أبي. الحزب الّذي ورثه البيك الكبير عن أبيه، وعملتُ أنا مثل حمار يتمتّع بقدرة عالية على الإقناع، ليرث البيك الصّغير الحزب عن أبيه. الحزب الّذي لن يرثه ابني إلّا على جثّتي المخضّبة بالعوز، ولن يرثه ابن البيك الّذي استجد كبره، ولو على جثّتي المخضّبة بالذّلّ.
كنتُ غبيًّا. أعرفُ. أشعر بالعار. أعترف، والاعترافُ بالخطأ فضيلة. لكنّني، ومع كلّ ذلك، أشيلُ في قلبي موقفًا طيّبًا واحدًا، وهو أنّني بسبب مؤخّرته الّتي كانت تتوق إلى كراسي مجلس النّواب، تعرّفتُ إليها.
كان الجوّ ربيعًا، والرّبيع في قرانا مُذهل. الزّهور تتفتّح، والعصافير تتفتّل، والعشب يخضوضر، والسّماء تكسو مُحيّاها هالة من الدّفء.
كانت بمفردها، تجلسُ تحت شجرة مُعمّرة. مجموعة من الكتب والدّفاتر والأقلام تُحوّطها من كلّ اتجاه، وخيوط من الشّمس تستقرُّ في عينيْها البُنيّتين.
أحسّت بوجودي، فرفعت رأسها مُستفسرةً. ألقيتُ السّلام عليها. عرّفتُها إلى نفسي، وطلبتُ منها الإذن لأحدّثها عن برنامج حزبي. ابتسمت وقالت: «إن كان لديك وقت لتضيّعه، فتفضّل».
سألتُها عن قصدها. «لن أنتخب البيك المُدلّل، ولا حزبه، ولا حليفه، ولا خصمه، ولا عدوّه، ولا أحد… لكن إن أردت أن تقول ما لديك، لتريح ضميرك، فلا بأس».
وقفتُ حائرًا أمام هذه الثّقة. استفزّتني. يُمكنُني أن أُقنعها. هذه موهبتي في الحياة. الإقناع موهبتي. أنا وُلِدتُ لأقنعَ النّاس، فكيف إن كان الأمرُ يتعلّق بحزبي؟ دمي لحزبي.
قعدتُ قربها تحت الشّجرة. أعطيتها مجموعة من الأوراق المصبوغة بالشّعارات، وبدأتُ… كانت تُصغي باهتمامٍ. تهزّ رأسها ببطء هُنا، وترفعُ حاجِبَيْها مُستغربةً هُناك.
وأنا بينَ الكلمة والكلمة أُراقبُ وجهها، وأتساءلُ عمّا تُخفي هذه المُلامحُ الجدّيّة… والسّؤال الأعظم، سؤال المليون دولار، هل اقتنعت أم لم تقتنع؟ اقتناعُها فوز ساحق يوازي فوزَ حزبي المُتوقّعَ أساسًا، أمّا عدم اقتناعها فخسارة قاتلة. مسٌّ بكرامتي السّياسيّة ومواهبي في الإقناع.
تشكّرتني على ما تفضّلتُ به من شرح وتفصيل قائلةً: «كلّ كلمة قلتها زادتني وعيًا ومعرفةً بأنّ قراري…». صمتت قليلًا تُحدِّقُ إليّ بنظراتٍ لم أفهمها، ثمّ أكملت: «بأنّ قراري كان صائبًا منذُ البداية… يُمكنك أن تُقنع والدَيَّ، فهما أساسًا يُحبّان البيك تِركَة أبيه البيك، وسينتخبان البيك الحفيد المُدلّل…أمّا أنا فلا».
«تركة أبيه… الحفيد المُدلّل… ماذا تقصدين؟! ما كلّ هذا الهُراء؟ أتعرفين عمّن تتحدّثين يا فتاة؟».
«أعرفُ جيّدًا عمّن أتحدّث يا فتى».
صحّحتُ لها: «لكنّ البيك ليس حفيدًا مُدلّلًا، لقد درس في أعظم جامعات العالم، يجيد التّحدّث بأربع لغات، ومكتبة بيته تكاد تختنق لكثرة ما فيها من كتب العلم والثّقافة والتّاريخ والأدب…».
قاطعتني: «وأنتَ في أيّ جامعة درست، وكم لغة تُجيد، وهل لديك المال لتشتري ما يكفيك من الطّعام؟».
انزعجت من ملاحظتها، وانجرفتُ في محاولة فاشلة لأُدافع عن نفسي: «أنا تعلّمتُ أيضًا، ومقتنعٌ بحياتي كما هي، وفخور بانتمائي إلى عائلة فقيرة. هل عليّ أن أحسد الرّجل على مال أبيه؟ فليصرفوا أموالهم كيفما يشاؤون».
أخذتْ نفسًا عميقًا: «اِسمع. أوّلًا، لا تُربّحني جميلة أنّ بيكك مُعلَّمٌ ويتحدّث اللّغات ولديه مقوّمات… أمّا مال أبيه، فإن كان مُحصّلًا بعرق جبينه، لما سأل أحد ولو قذفه في النّار، لكنّه مال منهوب. إنّه مالي ومالك. مالُنا نحن… لولا أبوه لما كان ابن بيكك الآن مُرشّحًا للانتخابات، بل ربّما كنت أنت مرشّحًا وفزت»، ختمتْ خطبتها بابتسامة.
ظللتُ أحدّقُ إليها، ومزيج من المشاعر يتناحر في داخلي. غضب. انزعاج. قهر. حقد. إعجاب… قمتُ وقبل أن أُغادر قلتُ لها: «ابن البيك سيفوز في الانتخابات». ابتسمت: «أعرف»، ثمّ عادت إلى كتبها ودفاترها، وغادرتُ أنا.
لم ألقَها مرّة أخرى إلّا يوم الانتخابات. كانت أعلامُ حزبنا وأعلامُ الأحزاب الأخرى تُحيط بنا من كلّ صوب. جيش من مندوبي الأحزاب كان يحتلّ مبنى الثّانويّة الرّسميّة… يُلاحقون هذا، ويُيسّرون أمر هذه، ويرافقون أولئك…
الدّنيا غارقة في حقل من مُلصقات الشّعارات السّياسيّة. عصبات الرّأس، قناني المياه، الأقلام، الأوراق، الطّاولات، الملابس، علب الأطعمة… كلّها ممهورة بشعار حزبنا… لم يكُن ينقصُ إلّا أن يوضع الشّعار على مؤخّرة ابن البيك.
من بين الجموع، رأيتها تخرج من غرفة الاقتراع. كان إبهامُها مُلطّخًا بالحبر الأزرق، راق لي تأمّله. ابتسامة كبيرة اخترقت وجهي، وعندما رفعتُ عينَيّ إلى وجهها، ابتَسمَت هي أيضًا.
«ألم أقل لكِ، لقد انتخبتِ البيك. كلامي أقنعكِ. فكّرتِ. عرفتِ الحق، فانتخبتِ البيك».
«لا، لم أنتخب».
«وماذا كنتِ تفعلين في الدّاخل، تُقشّرين البطاطا؟».
«مارستُ حقّي في…».
«الانتخاب!».
«الرّسم».
«رسم علامة الصّحّ قُرب اسم البيك».
«بل وجه مواطن مُبتسم وعلى رأسه حذاء البيك… قرب اسم البيك».
مُذ هذه اللّحظة، لم أستطِع أن أتحكّم برأس الحمار الّذي أنتعه فوق كتفَيّ. لقد استطاعت هذه الفتاة أن تأسر تفكيري. في الأيّام الّتي تلت يوم الانتخابات، كنتُ أسألُ نفسي: «هل أذهبُ إليها؟!».
لكنّني لم أكُن جريئًا بما فيه الكفاية. ماذا سأقول لها؟ لِمَ سأُلاحقُها أساسًا؟
مرّت الأيّام سريعًا، وقد قرّر أن يتزوّج البيك المُنتخب قبل سنة تقريبًا. عمّت الفرحة قريتنا والقُرى المجاورة. وصار عرسُ البيك الشّغل الشّاغل للرّجال والنّساء، الكبار والصّغار.
استدعيتُ من قِبل الحزب لأشارك في تنظيم العرس. عرسٌ كبيرٌ شعبيٌ سيُقام في ساحة القرية. البيك أحبّ أن يُشاركنا فرحته، ويدعونا جميعًا إلى عرسه. يا لتواضعه وكرمه!
لم أتوانَ عن طلب أسبوع عطلة غير مدفوع من عملي كرامة عَينَي البيك. ومع أنّ تنظيم العرس كان عملًا تطوّعيًّا، أي من دون أجرٍ مادّيٍّ، إلّا أنّني عملتُ ليل نهار، ليكون عرسًا عظيمًا تمامًا مثل «عرس الزّين».
واللّافتُ أنّه هو أو عروسه لم يأتيا لتفقّد التّحضيرات. ذهلتُ يومها. تعالا تفرّجا على الأقل، لم نقُل تعالا نظّفا الشّوارع وكنّساها، وأزيلا النّفايات المُتراكمة، وحوّلا الكهرباء من الدّولة إلى الاشتراك إلى المولّد! لكن لا، البيك يثقُ بنا ثقة عمياء، وإلّا لما تركنا نتصرّف كما نشاء. البيك أمّننا على «ليلة العمر».
وفعلًا كان يومًا من العمر. مئاتُ المدعوّين من مختلف المناطق جاؤوا ليحضروا العرس. الطّعام والشّراب على مدّ النّظر. الزّينة تتراقصُ في كلِّ مكانٍ، والشّجر يُغني فرحًا، ونسماتُ الهواء تتجاوز قميصي وتحفُّ ببطني وظهري. الجوّ ربيعيٌّ بامتياز، تمامًا مثلما كان قبل سنةٍ واحدة، يوم التقيتُ تلك الفتاة الّتي لم أعرِف اسمها بعدُ. هل تُراها تجيءُ إلى العرسِ؟
من بعيد، وصلت السّيّارة الّتي كانت القلوب بانتظارها. نزل العريس، ثمّ ساعد العروس… علت الزّغاريد، وقُرعت الطّبول، وصفّقت الأيدي، وملأت الأغاني السّاحة. هجم النّاسُ على العروسين يُباركون لهما، ويتمنّون الخلفة الصّالحة، أيّ مجموعة جديدة من «البكوات».
تجمّع الرّجال حول العريس. حملوه فوقهم وفوق أكتافهم، وراحوا يتقاذفونه، ويخضّونه تمامًا كما تخضّ عبوة عصير اشتريتها للتوّ من الدّكّان. والبيك الكبير، وسط هذه الزّحمة، كان جالسًا على كنبة عجيبة، نافِشًا ريشه، والمللُ يأكلُ روحه.
علت صيحة امرأة عجوز، هي الأكبر في قريتنا، بـ «إيويها» موغلة في القدم. ولمّا انتهت، قبّلتها العروس وقالت لها: «Oh dear, thank you, god bless you, you made my day»
ثمّ نظرت إلى الوراء، وشوشت أمّها بكلمات لم تصل إلى أحدنا. لكنّ ملامح وجهها الجاهلة بالكلمات فضحت سرّها.
حلّ اللّيل بعد صولات من الفرح والأغاني والرّقص وحلقات الدّبكة… جلستُ وحيدًا في مكانٍ بعيدٍ بعض الشّيء عن تجمّع النّاس الّذين لا يزالون يرقصون ويأكلون ويشربون.
سمعتُ حفيف أوراق الشّجرة فوق رأسي. التّراب رطبًا تفوح منه رائحة الرّبيع، والهواء تحوّل إلى نسمات باردة تُداعبُ الوجنتين والأنف. قلتُ لنفسي: «عرفتُ أنّها لن تجيء. يستحيلُ أن تجيء. لربّما هي مشغولة بكتبها، أو بحياتها الشّخصيّة… هل يا تُرى لديها حبيب أو مخطوبة أو متزوّجة؟».
من المدخل رأيتُ البيك العريس مع مجموعة من مرافقيه، يتحدّث عبر الهاتف، وقد بدا أنّه يتلقّى التّبريكات، بعد انتشار الصّور ومقاطع الفيديو في مواقع التّواصل الاجتماعيّ كالنّار في الهشيم.
ولمّا انتهى من مكالمته، ناداني أحد مرافقيه، وهو مَن كان يُتابعُ معنا أمور التّحضيرات. قال للبيك: «هذا هو الشّاب الّذي حدّثتك عنه، وهو الّذي حضّر…»، قاطعه البيك قائلًا لي: «آه، أهلًا، أهلًا»، ثمّ غادر مُسرعًا إلى الحفل. وبقيتُ أنا وحدي تحت هذه الشّجرة أُفكّر.
بعد أيّامٍ، بدأتِ الأخبار تطفو هُنا وهُناك عن «فضيحة» البيك… البيك أقام عُرسًا بمبالغ خياليّة في صالة خياليّة… في البداية بدت الأخبار طُفيليّة، فذاك الّذي أقام عُرسًا شعبيًّا مُذهلًا ما حاجته بعرس ثانٍ؟ لكنّ الصّور سُرِّبت، والأرقام والمبالغ وأسماء الضّيوف تهافتت على وقع الحديث عن وضع اقتصاديّ يُشبه الزّفت.
صعُب عليّ تصديق أنّ البيك قدّم حفلًا استعراضيًّا «شعبويًّا» في عرسه الأوّل، ليسترضي النّاس ويضحك عليهم. لكنّ الأدلة أثبتت صحّة «العرس الثّاني الخياليّ». رحنا نُبرّر الأمر ونكرّره حتّى آمنّا به وصدقناه: «لربّما أرادا أن يحتفلا مع أصدقائهما وعائلاتهما بعيدًا من فضول النّاس». من يدري؟
من حيث لا أدري، قفز إلى رأسي كلام سمعته قبل سنة: «أمّا مال أبيه، فإن كان مُحصّلًا بعرق جبينه، لما سأل أحد ولو قذفه في النّار، لكنّه مال منهوب. إنّه مالي ومالك. مالُنا نحن». رنّت في أذني الكلمتان الأخيرتان: «مالُنا نحن». وكان وقعُها قاسٍ كبلاطة قبر.
في أواخر أيّام الصّيف، بعد أشهر من عرس البيك، كنتُ في محلّ الأحذية حيثُ أعملُ بائعًا. رائحةُ القهوة تتسلّل من كلِّ مكان، وتختلط بأصوات زمامير السّيارات المتأتّية من الطّريق العام. كان المحلّ غارقًا في بحر من هدوء الجيوب المفرّغة من المال عندما فتحتِ الباب ودخلتْ.
نظرتْ إليّ، بعد لحظات تحديق، ضحكتْ. لقد عرفَتْني! لا تزال تذكرني!
«أهلًا! تفاجأتِ؟».
«أهلًا، وأهلَيْن، ممَّ؟».
«مِن أنّ ذاك الفتى الّذي يعملُ ليل نهار في الحزب، يعملُ أيضًا ليل نهار في بيع الأحذية؟».
«قلّة فرق؟».
لحظة صمتٍ طالت خلتها دهرًا، حتّى أعلنت هي انتهاءها: «الأحذية أرفع مقامًا طبعًا. الحذاءُ يحمي قدميك من القاذورات. أمّا أولئك الّذين يتنعّمون في السّلطة، فإنّهم قاذورات فكريّة وثقافيّة وروحيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. ولا يليقُ بالقاذورات إلّا أن يُدعس عليها بالحذاء».
لم تترك لي مجالًا لأنبس بكلمة، ولم أكن راغبًا في التحدّث أصلًا. منذُ مدّة فقدتُ رغبتي في الدّفاع عن أيّ أحد أو شيء… تابعت حديثها: «المهمّ، جئتُ لأشتري حذاءً جيّدًا مليحًا رخيصًا، يدوم العمر كلّه، ويُعمّر…».
اختارت حذاءً جيّدًا يُغنيها عن شراء واحد جديد سنة كاملة في مثل هذه الأوضاع الاقتصاديّة السّيّئة. وقبل أن تودّعني مُغادرةً، سمحتُ لنفسي بالتّطفّل عليها، فسألتها عن اسمها.
«أمل».
قالت اسمها ثمّ مضت.
جاءت أيّام الخريف لطيفة ذاك العام، لكنّ لطفها لم يُكتب له الحياة. في ليلةٍ، لم يعرف أحد ماذا حصل أو كيف. فجأة، ومن دون إشعار، وجدنا أنفسنا في الشّارع. نصرخُ بأعلى أصواتنا، ونُردّد كلمات وشعارات كادت توحِّدنا.
كان عُرسًا حقيقيًّا يفوق جمال أيّ عرسٍ رأته عيني… التقيتُها مرّة أخرى في ساحة العرس: في الشّارع. فرحتُ. كانت تحملُ علم البلاد، وكنت أحمل علم البلاد. سألتني غامزةً: «شلحت حزبك؟».
فأجبتها: «لا، لكنّني أطالب بحقوقي مثل الجميع». في هذه اللّحظة، اعترفتُ لنفسي بأنّني أحبّها، واتّخذتُ قراري: سأتزوّج هذه الفتاة…
ابتسمت أمل ابتسامة حلوة وكأنّها سمعتني، وقالت: «غدًا الأحلامُ كُلّها تتحقّق».
وعندما وُلِدَ «غدًا»، كان الخرابُ قد ملأ البلاد، والفوضى عمّت كلّ زاوية من زواياه. ثمّة من جاء، وقطّع الأمل قطعًا صغيرة جدًّا، حتّى صارت ذرّات عصيّة على الاكتشاف، ثمّ رمى كلّ ذرة في كوكب سيّار. لقد أضحى كلُّ شيء مرعبًا، كحقيقةٍ جارحةٍ تقفُ عاريةً من أيّ تجميل.
اتّصل بي مالك محلّ الأحذية. توقّعت اتّصاله. لقد صرتُ بلا عملٍ. المحلُّ ما عاد قادرًا على أن يُكمل. جمع صاحبُ المحلّ ماله وترك البلد. هاجر. في ما بعدُ اكتشفت أنّه: نجا.
عدتُ إلى غُرفتي الّتي تحوّلت إلى شرنقةِ إحباط. اعتكفتُ فيها أشهرًا طويلةً… لم أعرف خلال هذه الأشهر إلّا انتظار الكوارث، كارثة تلو الكارثة، ومشاهدة حياتي وهي تنهارُ حجرًا بعد حجر، بحصة بعد بحصة، إلى أن لم يبق منها غير الرّكام والحطام، وأطلال أبكي عليها.
مُذ أطبق الظّلام على ذاك «العرس»، لم أكلّم أمل، تلك الفتاة الّتي ما لنا من اسمها نصيب. صحيح أنّنا تبادلنا أرقام الهواتف، والتقينا، وتحدّثنا مُطوّلًا في أمور كثيرة ما عدا الحبّ… إلّا أنّني بعد ذلك قطعتُ علاقتي بها، من دون أن أجرؤ على البوح بما كنتُ أفكّر به لحظة كنّا في الشّارع، لأنّني عاطلٌ من العمل، لا أملك ثمن فطيرة، وأعتاش على راتب والدي الضّئيل.
بعد سنة كاملةٍ من عرس ابن البيك، عرفتُ من مواقع التّواصل الاجتماعيّ أنّها تركت البلد. هاجرت. ستُكملُ دراستها في الخارج. لا أعرفُ متى سافرت تحديدًا. ربّما بعد أشهر قليلة جدًّا من «عرس الشّارع» الّذي نهشته أنياب الحيوانات الضّارية.
هل أغضب أو أفرح أو ألعن حظّي؟ لا أعرف. ما أعرفه هو أنّني إنسان بلا قيمة؛ كائنٌ لا يصلح إلّا لتناول الطّعام، ومُتابعة المواقع الإلكترونيّة ونشرات الأخبار المحقونة سمًّا وقتلى وأرواحًا بريئة وضحايا وسرقات…
ارتديتُ ملابسي، وخرجتُ من المنزل. عندما لمس النّور عينيّ، زممتهما مُتألمًّا ومُحترقًا. توجّهت إلى قيادة الحزب. سلّمتُ بطاقتي، وتقدّمتُ باستقالتي النّهائيّة من المهام الّتي كنتُ أشيلها على كتفَيّ، في حزب سياسي همّه أن يشيل ما يقدر من تعبنا، ليكدّسه في جيوبه المتخمة. «شلحتُ» حزبي يا أمل، لكنّك لستِ هُنا.
خرجتُ من مبنى القيادة، وقد دخلتْ إلى أعماقي روح جديدة. تطهّرتُ. كأنّ الله أرادني أن أولد من جديد… إنسان حرٌّ لا يتبعُ أحدًا. إنسان لا يُقطّع أمعاءه جوعًا ليُتخَم كرش البيك. ولا يسمح للبرد أن يُهشّم عظامه، ليتدفّأ البيك. إنسانٌ يعيشُ ليعيشَ هو وكلّ الفقراء أمثاله.
في السّاحة، حيثُ أُقيمَ العرس الشّهير، كان جمع من متطوّعي الحزب الّذين أعرفهم يُعلّقون يافطات للبيك الصّغير الّذي صار كبيرًا، ويوزّعون الزّينة في كلّ مكان، ويحتفلون. سألتهم عن السّبب. أردتُ أن أقول لهم: «هل مات؟»، لكنّني لجمتُ رغبتي.
قال رجل أعرفه والفرحُ يكاد يحمله إلى الفضاء: «لقد رُزق البيك بصبيٍّ، وأسماهُ على اسم جدّه».
ابتسمتُ في وجهه ابتسامة شذر. لقد رُزق البيك بصبيٍّ صغير؟ «الله يهنيه». لكن هذا الرّجل المُحتفِلُ الآن، هو نفسه يحاولُ بشقّ الأنفس منذ سنوات أن يُعمّر غرفة صغيرة فوق منزل والدَيه.
لم أشأ أن أعكّر مزاجه. فليفرح…
مررتُ في كافّة الطّرقات الّتي أعرفها وأجهلها في قريتنا الكبيرة، حتّى قادتني قدماي إلى شجرة جلستُ تحتها قبل سنتين من اليوم. هذه المرّة جلستُ وحدي. تكوّرتُ، وسمحتُ لنفسي بالبكاء. تخيّلتُ أنّها ستأتي، ستناولني محرمة، وستقول: «لا بأس، أكثر من فرعون لم يُفرعِن». لكنّها ليست هُنا. إنّها بعيدة… في مكان بعيد… بعيدٍ…
دفنتُ رأسي في التّراب، ومرّغتُ آلامي بكلّ حبّة من الأرض، لعلّ قلبي يتيمّمُ بها… بكيت، صرختُ، غضبت… بصمتٍ لكي لا يسمعني أحد.
حملتُ غصّتي على ظهري كما تحملُ السّلحفاة بيتها. مشيتُ على مهل إلى البيت. وفي منتصف الطّريق، اقترب منّي الفريق الإعلاميّ لموقع الحزب على الإنترنت، وطلبوا إليّ أن أوجّه كلمة إلى ابن البيك وزوجته بمناسبة ولادة الصّبيّ الصّغير.
رفضتُ بأدب، وأكملتُ طريقي. لكنّهم أصرّوا ولحقوني. اعتذرتُ، فعاودوا اللّحاق بي. طلبت أن يتركوني وشأني. «لا يُعقل… أخبر البيك بما تتمنّى له ولابنه، ولو جملة». سألتهم: «هل فعلًا تريدون أن أقول جملة واحدة؟».
«طبعًا». سحبتُ نفسًا عميقًا، عدتُ بالذّاكرة إلى كلّ ما مرّ معي، مُذ التقيتُ بها، مُذ قالت لي إنّها لن تنتخب أحدًا، عرس الزّين، محلّ الأحذية، العرس في الشّارع، الفوضى والألم والعوز… حدّقت إلى الكاميرا، وقبل أن تخرج الكلمة من فمي، أزحتها بيدي، وطرقتُ عائدًا إلى البيت، وفي قلبي أمنية واحدة: «أن أركل مؤخّرة ابن البيك. وشكرًا».
لتحميل المجموعة القصصيّة كاملة اضغط/ي هُنا.
اقرأ أيضًا:
– يوم آخر مرّ من هُنا
– يوم ورثتُ Followers أبي
هذا المقال يحمل عمقًا إنسانيًا مؤلمًا يلامس قضايا اجتماعية وسياسية بشكل رمزي بليغ. أدهشني كيف استُخدمت التفاصيل اليومية والعلاقات الشخصية كأداة لرصد التفاوت الطبقي والفساد الذي ينعكس على مصير الأفراد. الحبكة تنقلنا من أجواء انتخابية مشحونة بالتناقضات إلى خيبات الأمل التي تعقبها، محملة بدلالات تعكس عبثية النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم.
من منظور شخص يحب تحليل الأعمال الأدبية، أجد أن اللغة الممزوجة بالسخرية والمرارة تُبرز مهارة الكاتبة في التعبير عن المواقف دون مباشرة أو خطابية. ربما كان الأمل الخافت الذي أطلّ عبر شخصية أمل، والاحتجاج الشعبي الذي بدا كعرس، يشيران إلى وميض حلم بالتغيير، وإن كان محاصرًا بالخراب.
شكراً على هذا النص الثري الذي يجبر القارئ على التأمل في معانيه وعلى طرح تساؤلات عن مسؤولياتنا تجاه مجتمعن
إعجابLiked by 1 person
check meals option منيو البيك
إعجابإعجاب