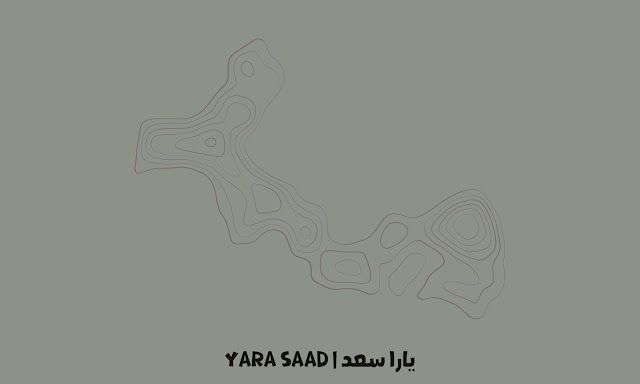
نُشِرَت في 23 شباط 2020
فتح بابَ غرفتي. سمعتُه يسحبُ قدَمَيْه على الأرض. اقتربَ من سريري. أغمضتُ عَيْنَيَّ، وسددتُ أذنيَّ. لا أريدُ أن أراه، أو أسمعَه. اقتربَ منّي أكثر، شعرتُ بلزوجة جسده، ونتانة رائحته. وضع يدَه على الغطاء، وسحبَه ببطء.
صرختُ به: «أسبوعان، ولم تدعني أنام يا ابن الكلب». ابتسمَ، وظلّ يراوغُ.
«كفاك عهرا يا ابن الـ…».
أجابني بميوعة: «لا تكنْ عبيطا يا رجل، مَنْ سَرَقَ في موطنِكَ عاشَ، ومَنْ تعفّفَ وَأدَهُ الشِّحارُ».
أسابيع مرّت، وهذا الكائنُ الكريهُ يُلاحقني… يُسمّم أفكاري، يلتصقُ بي ويقول: «اسرقْ تنجُ، أو تَمُتْ وزوجتك وأطفالك، مثل كلاب الشّارع».
فيما أنا أهربُ، أهرولُ، أركضُ، أطردُه، أهاجمُه… حاولتُ أن أُنقّبَ في دنياي عن خيارات أخرى تُنقذُني، غير هذا الكائن، لكن ماذا أفعلُ إن كان الفقراءُ لا يملكون ترفَ الخيارات؟
لا خيارات أمامنا. الوقتُ تأخّر. الأفكار اندثرتْ. الإحساس تفتّتَ. الطُّمأنينة انزلقتْ، وتحطّمتْ جمجمتها. كلّ شيء مات؛ كلّ شيء… حتّى عصافير بطوننا الّتي تنشطُ عندما نجوعُ، جاعت هي الأخرى، وماتتْ.
نزل النّاس إلى الشّارع، فالتحقتُ بهم. صرخنا وغضبنا وثُرنا، ثمّ… ثمّ توالت الأحداث: الدولار قضّ مضجع اللّيرة… تقاضيتُ نصفَ راتب… لم أتقاضَ ليرة… «شقا العمر» المتواضع جدًّا ابتلعه أحد المصارف، بعد جولات وصولات من التّقطير… فقدتُ وظيفتي الّتي حصلتُ عليها بـ «طلوع الرّوح».
لم أجرؤ على البحث عن عمل.
شهاداتي الكثيرة الّتي ظننتُها أشدّ سحرا من بساط علاء الدّين، لم تصلح حتّى لتكون خرقةً أمسحُ بها حذاء أحد لصوص هذا البلد السّائب.
وأخيرا، وجدتُ نفسي في الشّارع، أبيعُ الماء والمحارم، وأخسرُ أكثر ممّا أكسب. وفي المساء، أرجع إلى منزلي خَجِلًا مُطأطأ الرّأس.
أجتازُ العتبة، وأنا أعرفُ أنّ الشّيءَ الباردَ هذا، ليس بيتي. إنّه مقبرةٌ، والموتى فيها نصفُ أحياء.
في السّابق، كنتُ أتشوّقُ لأفتحَ الباب، وأسمعَ أطفالي يغنّون أغنيةَ أترابهم الشّهيرة: «إجى بابا…». كانت الحياةُ تولدُ في شراييني كلّما لمسني أحدهم. أمّا اليوم، فما عاد في المنزل أطفال فرحون، بل أطفال جياع ومرضى…
مُذ كنتُ صغيرا ووالدي يُردّد: «بكرا الوضع بيتحسّن، وبصير عنّا أحسن بلد». صدّقتُه آنذاك.
درستُ حتّى كادت تبيّضُ عيناي. نفختُ روحي بأمنيات المستقبل. تزوّجتُ، وأنجبتُ، وصار عندي نصف دزّينة من الأفواه الجائعة، والبطون الخاوية، والأقدام الحافية.
تأخّرتُ حتّى اكتشفتُ أنّ «السّذاجة» مثل «التّعاسة» تُوَرَّثُ، وأنّ شيئًا لن يتحسّن.
من أينَ أبدأ، ولمن أشتكي، وكلّنا في الهواء سواء؟
قرضٌ بفوائد أغلى من بقرة جُحا… أجرة منزل، قسط مدارس، فاتورة كهرباء ومولّد وماء وهاتف وإنترنت… طّعام، شراب، ملبس، طبابة…
أنا لم أصِرْ على الحضيض، أنا الحضيض! فماذا عساه الحضيضُ أن يفعل؟
صوتٌ كريهٌ تأبّطَ رأسي وأجابني: «مَنْ سَرَقَ في موطنِكَ عاشَ، ومَنْ تعفّفَ وَأدَهُ الشِّحارُ».
سمعتُها من جديد. سرق. موطن. عاش. شحار. تعفّف. وَأدَهُ الشِّحارُ.
وَأدَهُ الشِّحارُ.
وَأدَهُ الشِّحارُ.
وَأدَهُ الشِّحارُ.
همتُ على وجهي في الشّوارع والأزقّة. لعنتُ نفسي، لعنتُ حياتي، لعنتُ ذلك الكائن النّتن الّذي يُلاحقُني.
أطلقتُ العنان لدموعي.
أردتُ دائمًا أن أحيا حياة عاديّة، مثل تلك الّتي يعيشُها الملايين حول العالم. أردتُ فقط أن أكون إنسانًا يصلح للحياة وللحبّ وللسّلام. لم أكن أعرف قطّ، أنّ الأرض هذه ملعونة، ونحن عليها لا نصلح إلّا للموت.
لكنّني… لكنّني لستُ مُستعدّا، ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال أو لونٍ من الألوان، أن أرى أطفالي يموتون، ينزفون، يتفتّتون، يُعصرون. أنا أب، وهذا يفوق قدرتي!
وفجأة، وجدتُ نفسي أبحثُ عن ذلك الكائن الكريه، عن «خياري»، خياري الوحيد… وهو أن أسرقَ لأطعم أطفالي.
سألتُ نفسي: «وماذا عساي أن أسرق، وكلّ الأشياء في هذا البلد أمست بلا قيمة؟ ومن أسرقُ، والنّاس كلّهم في الشّحار سواسية؟».
حدّدتُ هدفي: سأسرقُ بيت أحد الأغنياء… سرقة لقمة أو لقمتين لن تثقلَ كاهلهم، بل ستسدّ القليل من جوع أطفالي.
راقبتُ المنزلَ، وأصحابَ المنزل. جمعتُ عنهم المعلومات، وبتّ أعرف عنهم أكثر ممّا يعرفون هم عن أنفسهم. لم يتبقَّ لي، إلّا الانقضاض على ما يملكون، وجعله ملكًا لي، أنا وأطفالي، وبعض المساكين الّذين يعانون المصائب في هذا البلد.
حان موعدُ السّرقة. ابتسم ذلك الكائن النّتن، وكاد ينفجرُ ويتلاشى لشدّة فرحه.
رافقني إلى حيثُ سأسرقُ. اِلتَحَمَ بروحي بفجور، وراح يتراقصُ مُردّدا: «مَنْ سَرَقَ في موطنِك عاشَ، ومَنْ تعفّفَ وَأدَهُ الشِّحارُ».
تفصّدتِ السّماء مطرا غزيرا، وراحت القطرات تنصبّ عليّ… تصاعدتِ الحرارةُ من جسدي، وكادت تشنقُني. ارتجفَ قلبي، وارتجفتِ الدّماءُ في شراييني. لم يخطرْ لي يومًا أنّ السّرقةَ مخيفةٌ أكثر من الجوع.
خلعتُ ملابسي لعلّ البرودة من حولي تقتحمُني… لكن لا شيء… فقدتُ السّيطرة على نفسي. وقعتُ أرضًا، واستسلمت.
صرخ فيّ ذلك الكائن النّتن الكريه: «قُمْ، لا تقعدْ… مَنْ تعفَّفَ وَأدَهُ الشِّحارُ».
أمعنتُ النّظر في وجهه المتعفّن، في فمه، وأسنانه، وأنفه، وحاجبيه الكثّين… تسلّلَ الصّقيعُ إلى أعماقي، فاشتعلتُ غضبا. مسكتُ حجرا، وباغتّه بضربة على رأسه، ثمّ ضربتين، ثلاث، أربع، سبعين… وبعدها صرتُ كالمجنون، أضربُه وأرقصُ، أرقصُ وأضربُه… حتّى مات، وكنتُ أظنّ أنّ أمثاله لا يموتون!
تركتُ جثّته هامدة في الأرض، ومشيتُ تعيسا إلى بيتي.
في البيت، كلُّ الأشياء كانت ميتةً، مقتولة، مخنوقة، معذّبة… كلُّ الأشياء من حولي ملعونة بلعنة أبديّة.
ذهبتُ إلى سريري، ولأوّل مرّة منذ أسابيع، نمتُ قرير العين مطمئنّ البال، وقد اتّخذتُ قراري: سأنتصرُ على هذه الظّروف.
لكنّ أحدًا لن يسمح لي، وما أكثر الّذين لن يسمحوا لنا بالعيش!
صباح اليوم التّالي، اقتحم المفوّضون بأمن البلاد الأغراء بيتي. سحبوني من سريري، ثمّ حطّموا ما بقي لي من كرامة، من دون رحمة أو رأفة.
شَيَّعَتِ البلادُ كلّها جثّة ذلك الكائن الكريه، وأُعلِنَ الحدادُ لأيّام كثيرة، ونُصِبَتِ التّماثيلُ له على طولِ البلاد.
أمّا أنا، فقد سُجِنتُ بين حيطان أربعة. أُحدّثها عن خيبتي، فتحدّثني عن خيبتها. أبكي، فتبكي القيود بين يديّ. أنتحبُ، فتنتحبُ القضبان.
وفي كلّ لحظة، كنّا نسمعُ صوتَهُ يُقهقه، ويقول: «مَنْ سَرَقَ في موطنك عاشَ، وإن ماتَ غمرَتُه العظمةُ… ومَنْ تعفّفَ وَأدَهُ الشِّحارُ، وَأدَهُ الشِّحارُ، وَأدَهُ الشِّحارُ».